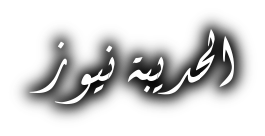الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 21:40
بالنسبة إلى واشنطن ما يحدث ليس أكثر من انقلاب عسكري في دولة أفريقية ليس لهم فيها مصالح حيوية
في منتصف أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع السودان حول الخلافات العميقة على مستوى السلطة بين المكونين العسكري والمدني. وكانت أبرز تلك الاختلافات هي آليات استرجاع الأموال المنهوبة، وعمل الحكومة، وإصلاح المؤسسة العسكرية والتداول على الحكم.
وحتى أحداث 25 أكتوبر وما بعدها، لم تنجح الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر للخروج بالسودان من هذه الأزمة، لأنها تركز على امتلاك خيوط بديلة لإدارة الأوضاع السودانية، وفق ما يتناسب مع الرمال المتحركة في الإقليم.
ومن أهم السمات اللافتة للنظر هي انتظار بعض القوى السياسية الداخلية الحل الأميركي، بينما تكبلها أزمات الهوية السياسية والإثنية والمناطقية التي تعاني منها في ثقافتها الداخلية.
وهنا، يمكن اعتبار نظرية ابن خلدون في مفهوم الدولة ونشوئها التي تتجه إلى “تحديد العناصر الديناميكية التي تحقق التغير المحوري للقوة السياسية من خلال مفهوم العصبية”، عاملاً مهماً وراء المواقف المختلفة )ويراها البعض مزدوجة(، وانعدام الوحدة في شأن إجراءات الولايات المتحدة ضد السودان.
ومع ذلك، مددت الولايات المتحدة حالة الطوارئ حول الوضع في دارفور، واستخدم الكونغرس الأميركي باتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري لغة إدانة صريحة ضد إجراءات قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الأخيرة، وكل من شارك في الانقلاب.
دوافع التدخل الأميركي
لطالما حثت الولايات المتحدة المكونين المدني والعسكري على العمل سوياً من أجل الانتقال إلى نظام حكم مدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهذا ما عُدَّ خطوة إيجابية وضرورية في التحول المهم لعلاقة واشنطن مع الخرطوم بعد ثورة ديسمبر )كانون الأول( 2018، وإسقاط نظام عمر البشير في أبريل )نيسان( 2019.
وهذا الموقف هو ما ترغب الديمقراطيات الليبرالية في إظهاره، بهدف تقييد الانقلابات العسكرية في أفريقيا عموماً وفي سودان ما بعد الثورة خصوصاً. لكن هناك تعقيدات كثيرة تحيط بهذه الرغبة الليبرالية التي تتنزل من علٍ على حكومات تتقاطع فيها الصراعات الداخلية، علاوة على انعكاس آثارها الوخيمة على الأمن الإقليمي، ما يضع قدرة السودان على صياغة نظام حكم بالتوافق بين المكونين، وصولاً إلى حكومة مدنية بعد الانتخابات، في المحك.
هل نجحت واشنطن في اختراق جدار الأزمة السودانية؟
قد لا يمثل السودان أهمية استراتيجية مباشرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكن ينبع الاهتمام به بسبب مزيج من التنافس بين القوى الكبرى على منطقة القرن الأفريقي، ما يجعل سياق هذه الأزمة له تداعيات وتكاليف قد تسفر عن وضع متوتر يتجاوزه إلى المحيط الإقليمي.
وتجاوز اندلاع صراع الحكم بين المكونين المدني والعسكري، بروز تضارب أهداف الطرفين المعيارية للدرجة التي صعب معها التوفيق بينهما، إلى إلحاق التوتر بإقليم القرن الأفريقي الهش، حيث تتشابك مصالح المنطقة الأمنية والاقتصادية، التي تتمثل في شراكة اقتصادية وسياسية تتجسد في الاتحاد الأفريقي بفروعه ومنظمة الإيغاد وغيرها من المنظمات الإقليمية.
أضعف عدم تركيز الولايات المتحدة على الداخل السوداني، والنظر إلى الساحة الأمنية الإقليمية، جدوى التفاوض الداخلي. وذلك، إضافة إلى ما جرى تداوله في نطاق ضيق تعليقاً على التحركات الأميركية، وهو أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان )يونيتامس( فولكر بيرتس، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي، عندما التقى كل منهم بحمدوك والبرهان كانوا يبثون رسائل مطمئنة لكليهما بقرب حل القضية، وهو ما سماه أحد الوسطاء “التفاوض بالمراسلة”، بينما دانت التصريحات الصادرة منهم الانقلاب، ونادت بسيادة القانون، وضرورة تسليم السلطة للمدنيين.
تمديد الطوارئ
كان استخدام قانون الطوارئ من أصعب أشكال القوة التي يمكن أن تطبقها الولايات المتحدة ضد السودان إلى جانب الإجراءات الدبلوماسية. علاوة على ذلك، شكلت أزمة دارفور خطراً أمنياً مباشراً على البلاد من الداخل، وامتدادها إلى حقول النفط الليبي شمالاً، وارتكازات القوات الدولية في وسط وغرب أفريقيا المحاربة للأنشطة الإرهابية.
وكشفت حالات انعدام الأمن في المنطقة، إذ لم يتمكن السودان في ظل النظام السابق من معالجة الأزمة حتى باستقطاب الحركات المسلحة وتوقيع اتفاقيات السلام العديدة، فقد ظهر لاحقاً أن سياسات البشير في تقريب الحركات وضربها ببعضها تقف ضد حل الأزمة.
منذ أن أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان في 3 نوفمبر )تشرين الثاني( 1997، بموجب الأمر التنفيذي 13067، التي تشمل حظر السلاح وتجميد أصول بعض الأشخاص وحظر سفرهم، ظلت عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على السودان على خلفية الصراع في إقليم دارفور تجدد قبل الثالث من فبراير )شباط( من كل عام.
وعند الوصول إلى عام 2019، ظن السودانيون أن ثورتهم على النظام السابق ستوقف سريانها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قال “إن الأزمة لم تُحل بعد”. كما مُددت أيضاً في العام الماضي، ورأت الإدارة الأميركية أن “قرار تمديد العقوبات لن يؤثر سلباً على العلاقات التي شهدت تحسناً بين الولايات المتحدة والسودان في ظل أنشطة الحكومة الانتقالية المدنية”.
وفي 29 أكتوبر الماضي وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، رسالة إلى الكونغرس يطلب فيها تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان، متذرعاً هذه المرة بـ”استيلاء الجيش على الحكومة، واعتقال القادة المدنيين الذي يهدد تلك المكاسب الإيجابية”.
عصا العقوبات
لوحت الولايات المتحدة بعصا العقوبات على السودان، بافتراض أن الأزمة السودانية ربما تتحد مع بقية الأزمات فتقوض النظام الإقليمي، وتختبر استعداد الولايات المتحدة لإنقاذ الوضع دفاعاً عن المعايير الدولية الرئيسة، مثل حقوق الإنسان وتحقيق السلام ووحدة الأراضي وسيادة الدول، ضد انتهاكات الحروب والصراعات السياسية ليس في السودان وحده، بل في أجزاء من المنطقة كخطوة مباشرة تجاه فرض عقوبات أكثر صرامة جنباً إلى جنب مع الإجراءات الأخرى.
أما تهديد الولايات المتحدة بأنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد الانقلابيين، فهدفها يبدو إحداث تغيير في تصرف العسكر بتنفيذهم اعتقالات السياسيين والعنف السياسي في إدارة الدولة. وأدى الاستخدام المتزايد للعقوبات في السودان إلى إثارة الجدل حول فعاليتها، إذ إن نتيجتها خلال النظام السابق كانت سلبية وبطيئة في الغالب في إحداث التغيير المطلوب، ولم تحدث التأثير أو تغير من النظام إلا بعد عقدين من فرضها في عام 1997.
واصل النظام ممارسة الحكم والاستعانة ببعض الدول للالتفاف على العقوبات، وإقامة اقتصاد داخلي يسيّر الحكومة اقتصادياً ويمدها بالحياة، لكن الأثر الفعلي امتد للمواطنين الذين ثاروا وأسقطوا النظام أخيراً.
من خلال فهم التوقيت، الذي يجري فيه أخذ عديد من العوامل المختلفة في الاعتبار، لاتخاذ قرار العقوبات، يمكن الوصول إلى رؤية أوسع لهذه القرارات، وفهم أكبر للتعاون بين مختلف المجالات على المستوى المحلي وفوق الوطني والدولي، ويسلط الضوء على الاعتبارات والعوامل التي تأخذها في الاعتبار لاتخاذ القرار. فما تعده الولايات المتحدة منطلقاً من حماية مصالحها وسلوكها “العقلاني” يمكن أن يعتبره السودان سلوكاً غير عقلاني.
ينبع الموقف، الذي اتخذته الولايات المتحدة من عدم تقييمها الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للسودان، وهي في حقيقتها غير كافية لمواجهة البيئة الأمنية المتدهورة، لاجتياز الأزمة، وأن إعادة بناء مجال نفوذ الولايات المتحدة سيتسبب في تداعيات على منطقة القرن الأفريقي وعلى أفريقيا عامة.
بيان الكونغرس
دان الكونغرس الأميركي محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في سبتمبر )أيلول( الماضي، ومع تأكيد بيانه الصادر وقتها على مواصلة الولايات المتحدة الوقوف مع الشعب السوداني من أجل إقامة مجتمع سلمي وديمقراطي، ربما كان يساوره إحساس بأن المحاولة كانت تمهيداً لانقلاب آخر، وهو ما يفسر تشدده، على الرغم من تردد البيت الأبيض في وصف تلك الأحداث بأنها “انقلاب”.
وفي 6 نوفمبر الحالي طرح السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز والجمهوري جيم ريش بالتعاون مع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس والجمهوري مايك مكول، مشروع قرار يدين انقلاب السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش.
وهنا تظهر أهمية قرار قادة الكونغرس بوصفها أهمية معنوية فقط، لكنها تفتقر لقوة الإلزام القانونية بالنسبة إلى الإدارة والكونغرس معاً، بحسب وصف بعض الخبراء، الذين رأوا أنه “على الرغم من أن الرئيس الأميركي يمكن أن يتبنى إجراءات مماثلة عبر أمر تنفيذي، إلا أن ذلك مستبعد، لأن إجراء مثل هذا يفترض أن ما يحدث في السودان هو شغل شاغل لأميركا، وهذا غير صحيح. فبالنسبة إلى واشنطن ما يحدث في السودان ليس أكثر من انقلاب عسكري آخر في دولة أفريقية ليس لهم فيها مصالح حيوية. كما أن سلطة الرئيس الأميركي في مجال السياسة الخارجية ليست مفوضة له من الكونغرس، بل هي سلطة أصيلة له يمارسها وفقاً للمادة الثانية من الدستور”.
تُعد قرارات الولايات المتحدة ضد السودان أداة أساسية في سياستها الخارجية تستخدمها لتحقيق أهدافها وفقاً لمبادئ هذه السياسة، وعلى الرغم من وحدة الرؤية الأميركية في إدانة ما حدث، إلا أنه يُلاحظ أن هناك نهجاً مزدوج المسار يجمع بين الدبلوماسية والعقوبات مع الهدف الأساسي المتمثل في إحداث تغيير في السودان.
ومع ذلك، هناك الآن عدم وضوح حول ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات رداً على إجراءات البرهان الأخيرة، وما هو على المحك هو النظرة إلى التغيير الذي افترض البرهان أنه حسمه بتعيين مدنيين في مجلس السيادة بدلاً عن الوزراء المعتقلين.
إشارات داعمة
أظهرت زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي إلى الخرطوم، ولقائها الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، موقفاً يرسل إشارات عن دعمها لكلا المكونين في محاولة للحفاظ على التوازن بين ما تريده الولايات المتحدة من كل منهما، فهي لم تغلق الباب أمام البرهان، على الرغم من التأكيد على استعادة حكومة حمدوك.
في الوقت نفسه، بدا هذا التأكيد بالنسبة إلى المدنيين دون المستوى الأمثل، ومع ذلك، تبدو الاستراتيجية الأميركية غامضة بعض الشيء مقارنةً مع وضوح ما يريده كل من البرهان وحمدوك بشأن هذه القضية.
وبالنظر إلى ردة الفعل هذه يمكن تحديد ثلاث قضايا رئيسة تدور حولها التحركات الأميركية، الأولى أنه بالنظر إلى تجديد العقوبات، تحاول الحكومة أن تسوق رأياً مفاده أنها لن تحدث، وإن حدثت لن تشكل تهديداً مباشراً ما يعني انفصامها عن قواعدها الشعبية المتأثرة بالعقوبات مباشرة. والثانية تكمن في أن خطاب المسؤولين الأميركيين المُستتر يلمح إلى أن مفهوم التهديد للسودان لم يهدأ حتى يُبعث من جديد.
أمّا الثالثة فهي الاختلاف في تقدير الولايات المتحدة للسياسات الأمنية لدول القرن الأفريقي، التي أصبحت أكثر وضوحاً بسبب الأزمة الإثيوبية، لكنها غير واضحة تماماً بالنسبة إلى السودان.
منى عبد الفتاح
بالنسبة إلى واشنطن ما يحدث ليس أكثر من انقلاب عسكري في دولة أفريقية ليس لهم فيها مصالح حيوية
في منتصف أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع السودان حول الخلافات العميقة على مستوى السلطة بين المكونين العسكري والمدني. وكانت أبرز تلك الاختلافات هي آليات استرجاع الأموال المنهوبة، وعمل الحكومة، وإصلاح المؤسسة العسكرية والتداول على الحكم.
وحتى أحداث 25 أكتوبر وما بعدها، لم تنجح الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر للخروج بالسودان من هذه الأزمة، لأنها تركز على امتلاك خيوط بديلة لإدارة الأوضاع السودانية، وفق ما يتناسب مع الرمال المتحركة في الإقليم.
ومن أهم السمات اللافتة للنظر هي انتظار بعض القوى السياسية الداخلية الحل الأميركي، بينما تكبلها أزمات الهوية السياسية والإثنية والمناطقية التي تعاني منها في ثقافتها الداخلية.
وهنا، يمكن اعتبار نظرية ابن خلدون في مفهوم الدولة ونشوئها التي تتجه إلى “تحديد العناصر الديناميكية التي تحقق التغير المحوري للقوة السياسية من خلال مفهوم العصبية”، عاملاً مهماً وراء المواقف المختلفة )ويراها البعض مزدوجة(، وانعدام الوحدة في شأن إجراءات الولايات المتحدة ضد السودان.
ومع ذلك، مددت الولايات المتحدة حالة الطوارئ حول الوضع في دارفور، واستخدم الكونغرس الأميركي باتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري لغة إدانة صريحة ضد إجراءات قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الأخيرة، وكل من شارك في الانقلاب.
دوافع التدخل الأميركي
لطالما حثت الولايات المتحدة المكونين المدني والعسكري على العمل سوياً من أجل الانتقال إلى نظام حكم مدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهذا ما عُدَّ خطوة إيجابية وضرورية في التحول المهم لعلاقة واشنطن مع الخرطوم بعد ثورة ديسمبر )كانون الأول( 2018، وإسقاط نظام عمر البشير في أبريل )نيسان( 2019.
وهذا الموقف هو ما ترغب الديمقراطيات الليبرالية في إظهاره، بهدف تقييد الانقلابات العسكرية في أفريقيا عموماً وفي سودان ما بعد الثورة خصوصاً. لكن هناك تعقيدات كثيرة تحيط بهذه الرغبة الليبرالية التي تتنزل من علٍ على حكومات تتقاطع فيها الصراعات الداخلية، علاوة على انعكاس آثارها الوخيمة على الأمن الإقليمي، ما يضع قدرة السودان على صياغة نظام حكم بالتوافق بين المكونين، وصولاً إلى حكومة مدنية بعد الانتخابات، في المحك.
هل نجحت واشنطن في اختراق جدار الأزمة السودانية؟
قد لا يمثل السودان أهمية استراتيجية مباشرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكن ينبع الاهتمام به بسبب مزيج من التنافس بين القوى الكبرى على منطقة القرن الأفريقي، ما يجعل سياق هذه الأزمة له تداعيات وتكاليف قد تسفر عن وضع متوتر يتجاوزه إلى المحيط الإقليمي.
وتجاوز اندلاع صراع الحكم بين المكونين المدني والعسكري، بروز تضارب أهداف الطرفين المعيارية للدرجة التي صعب معها التوفيق بينهما، إلى إلحاق التوتر بإقليم القرن الأفريقي الهش، حيث تتشابك مصالح المنطقة الأمنية والاقتصادية، التي تتمثل في شراكة اقتصادية وسياسية تتجسد في الاتحاد الأفريقي بفروعه ومنظمة الإيغاد وغيرها من المنظمات الإقليمية.
أضعف عدم تركيز الولايات المتحدة على الداخل السوداني، والنظر إلى الساحة الأمنية الإقليمية، جدوى التفاوض الداخلي. وذلك، إضافة إلى ما جرى تداوله في نطاق ضيق تعليقاً على التحركات الأميركية، وهو أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان )يونيتامس( فولكر بيرتس، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي، عندما التقى كل منهم بحمدوك والبرهان كانوا يبثون رسائل مطمئنة لكليهما بقرب حل القضية، وهو ما سماه أحد الوسطاء “التفاوض بالمراسلة”، بينما دانت التصريحات الصادرة منهم الانقلاب، ونادت بسيادة القانون، وضرورة تسليم السلطة للمدنيين.
تمديد الطوارئ
كان استخدام قانون الطوارئ من أصعب أشكال القوة التي يمكن أن تطبقها الولايات المتحدة ضد السودان إلى جانب الإجراءات الدبلوماسية. علاوة على ذلك، شكلت أزمة دارفور خطراً أمنياً مباشراً على البلاد من الداخل، وامتدادها إلى حقول النفط الليبي شمالاً، وارتكازات القوات الدولية في وسط وغرب أفريقيا المحاربة للأنشطة الإرهابية.
وكشفت حالات انعدام الأمن في المنطقة، إذ لم يتمكن السودان في ظل النظام السابق من معالجة الأزمة حتى باستقطاب الحركات المسلحة وتوقيع اتفاقيات السلام العديدة، فقد ظهر لاحقاً أن سياسات البشير في تقريب الحركات وضربها ببعضها تقف ضد حل الأزمة.
منذ أن أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان في 3 نوفمبر )تشرين الثاني( 1997، بموجب الأمر التنفيذي 13067، التي تشمل حظر السلاح وتجميد أصول بعض الأشخاص وحظر سفرهم، ظلت عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على السودان على خلفية الصراع في إقليم دارفور تجدد قبل الثالث من فبراير )شباط( من كل عام.
وعند الوصول إلى عام 2019، ظن السودانيون أن ثورتهم على النظام السابق ستوقف سريانها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قال “إن الأزمة لم تُحل بعد”. كما مُددت أيضاً في العام الماضي، ورأت الإدارة الأميركية أن “قرار تمديد العقوبات لن يؤثر سلباً على العلاقات التي شهدت تحسناً بين الولايات المتحدة والسودان في ظل أنشطة الحكومة الانتقالية المدنية”.
وفي 29 أكتوبر الماضي وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، رسالة إلى الكونغرس يطلب فيها تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان، متذرعاً هذه المرة بـ”استيلاء الجيش على الحكومة، واعتقال القادة المدنيين الذي يهدد تلك المكاسب الإيجابية”.
عصا العقوبات
لوحت الولايات المتحدة بعصا العقوبات على السودان، بافتراض أن الأزمة السودانية ربما تتحد مع بقية الأزمات فتقوض النظام الإقليمي، وتختبر استعداد الولايات المتحدة لإنقاذ الوضع دفاعاً عن المعايير الدولية الرئيسة، مثل حقوق الإنسان وتحقيق السلام ووحدة الأراضي وسيادة الدول، ضد انتهاكات الحروب والصراعات السياسية ليس في السودان وحده، بل في أجزاء من المنطقة كخطوة مباشرة تجاه فرض عقوبات أكثر صرامة جنباً إلى جنب مع الإجراءات الأخرى.
أما تهديد الولايات المتحدة بأنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد الانقلابيين، فهدفها يبدو إحداث تغيير في تصرف العسكر بتنفيذهم اعتقالات السياسيين والعنف السياسي في إدارة الدولة. وأدى الاستخدام المتزايد للعقوبات في السودان إلى إثارة الجدل حول فعاليتها، إذ إن نتيجتها خلال النظام السابق كانت سلبية وبطيئة في الغالب في إحداث التغيير المطلوب، ولم تحدث التأثير أو تغير من النظام إلا بعد عقدين من فرضها في عام 1997.
واصل النظام ممارسة الحكم والاستعانة ببعض الدول للالتفاف على العقوبات، وإقامة اقتصاد داخلي يسيّر الحكومة اقتصادياً ويمدها بالحياة، لكن الأثر الفعلي امتد للمواطنين الذين ثاروا وأسقطوا النظام أخيراً.
من خلال فهم التوقيت، الذي يجري فيه أخذ عديد من العوامل المختلفة في الاعتبار، لاتخاذ قرار العقوبات، يمكن الوصول إلى رؤية أوسع لهذه القرارات، وفهم أكبر للتعاون بين مختلف المجالات على المستوى المحلي وفوق الوطني والدولي، ويسلط الضوء على الاعتبارات والعوامل التي تأخذها في الاعتبار لاتخاذ القرار. فما تعده الولايات المتحدة منطلقاً من حماية مصالحها وسلوكها “العقلاني” يمكن أن يعتبره السودان سلوكاً غير عقلاني.
ينبع الموقف، الذي اتخذته الولايات المتحدة من عدم تقييمها الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للسودان، وهي في حقيقتها غير كافية لمواجهة البيئة الأمنية المتدهورة، لاجتياز الأزمة، وأن إعادة بناء مجال نفوذ الولايات المتحدة سيتسبب في تداعيات على منطقة القرن الأفريقي وعلى أفريقيا عامة.
بيان الكونغرس
دان الكونغرس الأميركي محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في سبتمبر )أيلول( الماضي، ومع تأكيد بيانه الصادر وقتها على مواصلة الولايات المتحدة الوقوف مع الشعب السوداني من أجل إقامة مجتمع سلمي وديمقراطي، ربما كان يساوره إحساس بأن المحاولة كانت تمهيداً لانقلاب آخر، وهو ما يفسر تشدده، على الرغم من تردد البيت الأبيض في وصف تلك الأحداث بأنها “انقلاب”.
وفي 6 نوفمبر الحالي طرح السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز والجمهوري جيم ريش بالتعاون مع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس والجمهوري مايك مكول، مشروع قرار يدين انقلاب السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش.
وهنا تظهر أهمية قرار قادة الكونغرس بوصفها أهمية معنوية فقط، لكنها تفتقر لقوة الإلزام القانونية بالنسبة إلى الإدارة والكونغرس معاً، بحسب وصف بعض الخبراء، الذين رأوا أنه “على الرغم من أن الرئيس الأميركي يمكن أن يتبنى إجراءات مماثلة عبر أمر تنفيذي، إلا أن ذلك مستبعد، لأن إجراء مثل هذا يفترض أن ما يحدث في السودان هو شغل شاغل لأميركا، وهذا غير صحيح. فبالنسبة إلى واشنطن ما يحدث في السودان ليس أكثر من انقلاب عسكري آخر في دولة أفريقية ليس لهم فيها مصالح حيوية. كما أن سلطة الرئيس الأميركي في مجال السياسة الخارجية ليست مفوضة له من الكونغرس، بل هي سلطة أصيلة له يمارسها وفقاً للمادة الثانية من الدستور”.
تُعد قرارات الولايات المتحدة ضد السودان أداة أساسية في سياستها الخارجية تستخدمها لتحقيق أهدافها وفقاً لمبادئ هذه السياسة، وعلى الرغم من وحدة الرؤية الأميركية في إدانة ما حدث، إلا أنه يُلاحظ أن هناك نهجاً مزدوج المسار يجمع بين الدبلوماسية والعقوبات مع الهدف الأساسي المتمثل في إحداث تغيير في السودان.
ومع ذلك، هناك الآن عدم وضوح حول ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات رداً على إجراءات البرهان الأخيرة، وما هو على المحك هو النظرة إلى التغيير الذي افترض البرهان أنه حسمه بتعيين مدنيين في مجلس السيادة بدلاً عن الوزراء المعتقلين.
إشارات داعمة
أظهرت زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي إلى الخرطوم، ولقائها الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، موقفاً يرسل إشارات عن دعمها لكلا المكونين في محاولة للحفاظ على التوازن بين ما تريده الولايات المتحدة من كل منهما، فهي لم تغلق الباب أمام البرهان، على الرغم من التأكيد على استعادة حكومة حمدوك.
في الوقت نفسه، بدا هذا التأكيد بالنسبة إلى المدنيين دون المستوى الأمثل، ومع ذلك، تبدو الاستراتيجية الأميركية غامضة بعض الشيء مقارنةً مع وضوح ما يريده كل من البرهان وحمدوك بشأن هذه القضية.
وبالنظر إلى ردة الفعل هذه يمكن تحديد ثلاث قضايا رئيسة تدور حولها التحركات الأميركية، الأولى أنه بالنظر إلى تجديد العقوبات، تحاول الحكومة أن تسوق رأياً مفاده أنها لن تحدث، وإن حدثت لن تشكل تهديداً مباشراً ما يعني انفصامها عن قواعدها الشعبية المتأثرة بالعقوبات مباشرة. والثانية تكمن في أن خطاب المسؤولين الأميركيين المُستتر يلمح إلى أن مفهوم التهديد للسودان لم يهدأ حتى يُبعث من جديد.
أمّا الثالثة فهي الاختلاف في تقدير الولايات المتحدة للسياسات الأمنية لدول القرن الأفريقي، التي أصبحت أكثر وضوحاً بسبب الأزمة الإثيوبية، لكنها غير واضحة تماماً بالنسبة إلى السودان.
منى عبد الفتاح