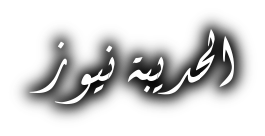الإثنين 20 يونيو 2022 - 19:11
د. مريم محمد عبد الله وقيع الله
وصول جموع الثوار في الخرطوم إلى القصر الجمهوري في يومي 19 و25 ديسمبر الجاري، رغم الاستعدادات الأمنية غير المسبوقة والتي تنذر بارتكاب مجازر قد تفوق ما حدث في يوم 17 نوفمبر، يدل على استعداد الديسمبريين لتقديم مزيد من التضحيات في سبيل تحقيق حلمهم بالدولة المدنية الديمقراطية. لكنه في نفس الوقت كشف أن هذا الزخم الثوري غير المسبوق لا يزال يفتقد للقيادة السياسية المتحدة وخريطة طريق توضح ماذا بعد الوصول إلى ساحة القصر الجمهوري. معلوم أن هذه الربكة بسبب عدم قدرة قوى الثورة على تشكيل قيادة متحدة جديدة بعد تصدع تحالف قوى الحرية والتغيير الذي نجح في قيادة الثورة حتى إسقاط رأس النظام البائد في أبريل 2019، ولا أحد ينكر أن لجان المقاومة استطاعت سد الفراغ وقيادة الحراك الثوري حتى الآن، وفرضت سيادتها على مجريات الأحداث، على الرغم من أن انقلاب 25 أكتوبر لم يتمكن من تشكيل حكومته ولا شرعنة سلطته داخلياً أو خارجياً، حتى بعد توقيع الإعلان السياسي مع د. حمدوك، إلا أن ذلك لا يعني سهولة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي، بل بالأحرى يؤكد ذلك على عدم قدرة الانقلابيين على خلق وضع مستقر يعيد سلطة النظام البائد كما يحلم بعضهم، ولا خلق نظام سلطوي جديد كما يحلم البعض الآخر المسنود من دول إقليمية وعالمية. وبالتالي فإن قيام نظام سلطوي أحادي غير وارد، فهناك خياران فقط: إما استعادة مسار التحول الديمقراطي الذي يسمح ببناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة، أو الانزلاق في عنف واسع النطاق لن تقتصر آثاره على السودان، بل ستؤثر على الأقاليم المجاورة أفريقياً وعربياً، بل ستصل آثاره إلى أوروبا.
رغم أن قوى ثورة ديسمبر لديها إرادة قوية للتغيير وهدف واضح هو تحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة، إلا أن الخطأ الاكبر الذي وقعت فيه قيادات تحالف الحرية والتغيير أنهم بدأوا في التناحر وحولوا الاختلاف في الرؤى إلى خلاف بمجرد سقوط رأس النظام في أبريل 2019. والنتيجة كانت تصدع التحالف بأسرع مما كان متوقعاً، وبما أنهم كانوا بالفعل قد اتفقوا على ما يعرف بإعلان الحرية والتغيير الذي يعتبر مرجعية للانتقال المدني الديمقراطي )The terms of reference( كان يتوقع أن يشرعوا مباشرة في وضع استراتيجية لكيفية تحقيق هذا الانتقال على أرض الواقع، لكنهم قبل الاتفاق على ذلك دخلوا التفاوض وهم منقسمون. وهنا الحديث عن القيادات التي انفصلت عن قواعدها في هذه الفترة ومارست نوعاً من التعتيم غير المبرر، والنتيجة كانت الوثيقة الدستورية بعيوبها المعروفة. بدأت المرحلة الانتقالية في ظل هذا التشرذم، انشغل البعض بالمحاصصات لأخذ نصيبهم في الوزارات والوظائف القيادية، دون أن يدروا أنهم متورطون في العمل بمؤسسات لا يزال منسوبو النظام البائد والموالون له يتحكمون في كل مفاصلها. هذا يفضح جهلهم بهذا الواقع، ويؤكد عدم توفر استراتيجية أو خارطة طريق تحدد كيفية إحداث التغيير لمصلحة الدولة المدنية الديمقراطية. أما البعض الآخر ففضل لعب دور المعارضة وطالب بإسقاط حكومة الشراكة في تماهٍ غير مقصود مع مساعي فلول النظام البائد، وانتهي هذا الفصل بالانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية ووثيقتها الدستورية.
الدرس الذي يجب أن تستوعبه قيادات قوى الثورة هو أن التغيير من الحكم الأحادي السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن أن يقوم به فرد أو حزب أو تحالف حزبي محدود، ولا يمكن أن تقوم به مجموعة محدودة من النخب معزولة عن القاعدة الشعبية العريضة صاحبة المصلحة المباشرة من التغيير، لأن التغيير المنشود ليس تغييراً فوقياً باستبدال عسكريين بمدنيين أو منسوبي النظام البائد في المؤسسات بمنسوبي الأحزاب كما يعتقد البعض. بل هو تغيير جذري في منظومة الحكم بشكل كامل وإعادة بنائها وفقاً لأسس الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا لا يتم فقط بالنوايا الطيبة، بل يحتاج خطة محكمة تشارك في وضعها كل قوى الثورة، تبنى على قراءة شاملة للمشهد بكل تعقيداته، وتضع خارطة طريق واضحة ومرنة تحدد كيفية إحداث التغيير ومراحله. هذا يتطلب تشكيل قيادة متحدة ومتواصلة مع جماهير الثورة على كل المستويات، خاصة المستوى القاعدي، وهي الضمانة الوحيدة لتشكيل قوة شعبية متماسكة ذات وزن راجح في المعادلة السياسية، قادرة على إجبار العسكريين وفلول النظام البائد على التخلي عن أحلامهم بجر عجلة التاريخ إلى الوراء، وستجد في هذه الحالة الاحترام والثقة والدعم من الخارج كقوة تستطيع جلب الاستقرار لبلد له دور مفتاحي في استقرار المنطقة لموقعه الجغرافي. ورغم أن موقع السودان وثرواته المستباحة هو أحد أسباب التدخلات الإقليمية والدولية إلا أن استدامة الاستقرار له أهمية قصوى خاصة بالنسبة لأوروبا وأمريكا.
إن ضرورة تشكيل قيادة متحدة للثورة ليس عليها خلاف، إلا أن هناك رؤى مختلفة حول كيفية تشكيل هذه القيادة، في الآونة الأخيرة اتجهت الأنظار للجان المقاومة التي استطاعت قيادة الحراك الثوري في هذه المرحلة الحساسة تحت شعار “لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية”. وعلى ما يبدو أن الأحزاب السياسية التي شاركت في المرحلة السابقة اضطرت للتماشي مع هذا الشعار، والذي هو أقرب لطرح الأحزاب التي كانت تعارض الشراكة، وعلى رأسها الحزب الشيوعي. هناك أيضاً من يؤمل في أن يتوحد تجمع المهنيين الذي تفتت بسبب الخلافات بين الأحزاب ليقود الحراك مرة أخرى كما فعل في 2018. وآخرون يراهنون على قدرة الحراك الثوري على إفراز قيادة جديدة في الوقت المناسب ولا يرون داعياً للاستعجال، وفي نفس الوقت تعج الساحة السياسة بالكثير من المبادرات والمواثيق والبرامج المطروحة أمام قوى الثورة للاتفاق حولها، إلا أن الانقسام ما زال قائماً، وأعتقد أن السبب الأساسي يرجع للأحزاب السياسية التي يعتبر دورها مفتاحياً في توحيد قوى الثورة. فيما يلي سأحاول ترسيم منظومة قوى الثورة لشرح هذه الفكرة:
لقد ساهم الانقلابفي ترسيم حد فاصل بشكل أوضح بين مجموعتين: إحداهما تسعى لاستعادة النظام السلطوي القديم المبني على الهيمنة والتهميش وما يستبعه من قمع ومصادرة للحريات، والأخرى تسعى لتحقيق نظام مدني ديمقراطي تعددي مبني على قيم الحرية والسلام والعدالة، الجديد في الأمر هو انحياز معظم قادة الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا لكفة الانقلابيين. لن أسترسل كثيراً في تحليل القوى الانقلابية رغم أنها مهددة بالصراعات من الداخل مما سيضعفها لصالح قوى الثورة، بل سأركز هنا على ترسيم منظومة قوى الثورة التي يقع عليها عبء إسقاط النظام وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية.
قوى الثورة تتكون من مجموعتين رئيسيتين تختلفان في طبيعتيهما وتتكاملان في أدوارهما داخل هذه المنظومة: المجموعة الأولى تشمل الأحزاب السياسية وأخرى تشمل كل الشبكات غير الحزبية بما في ذلك: لجان المقاومة، المنظمات النسوية، النقابات والروابط المهنية، وغيرها من منظمات المجتمع المدني. لكل من الأحزاب السياسية مقاربة لكيفية إدارة مؤسسات الدولة واستغلال مواردها لفئات المجتمع المختلفة، وفي الغالب تستند هذه المقاربات على تصور نظري مبني على أسس ومبادئ محددة ونموذج عملي لكيفية الممارسة. رغم أن نسبة الأشخاص المنظمين في الأحزاب قد تكون ضئيلة إلا أن الغالبية العظمى غير المنتمية لأحزاب لديها ميول لحزب دون الآخر. تضح هذه الميول في العملية الانتخابية إذا كانت بالفعل تتم بنزاهة ووعي كامل بالفرق بين المقاربات المختلفة. القصد هنا ليس معرفة مدى شعبية هذه الأحزاب، بل الأهم هو إبراز هذا التنوع في وجهات النظر والإقرار بأن هناك مقاربات سياسية مختلفة. فكرة الدولة المدنية الديمقراطية تبدأ من هذا المبدأ، وهو الإقرار بالتنوع ومبدأ الحرية في أن يتبنى كل شخص المقاربة التي يتفق معها ويرى أنها الأنسب أو التي تلبي مصالحه، وفي نفس الوقت لدى هذه الأحزاب الحق في الترويج لمشروعها إعلامياً، فلا ديمقراطية دون أحزاب، فمن يرفض الأحزاب الموجودة يجب أن ينخرط مباشرة في تشكيل حزب جديد يمكن أن يتنافس مع الأحزاب القائمة دون إقصائها، فلكل مقاربته للحلول السياسية ولديه جماهيره. أما بالنسبة للشبكات غير الحزبية فهي في الغالب تحاول التركيز على مطالب وحقوق الفئات المختلفة وإلقاء الضوء على مدى تأثر متطلبات الحياة اليومية للمجموعات المختلفة بالسياسات والممارسات المحددة، وبالتالي يتقاطع مجال اهتمامها مع المقاربات والممارسات السياسية المختلفة. وفي نفس الوقت فإن الناشطين في هذه الشبكات في الغالب يتبنون مقاربات سياسية مختلفة لتحقيق مطالبهم وحقوقهم الفئوية، لذا فهم أيضاً مجموعات غير متجانسة سياسياً.
الشكل أدناه يوضح هذه الفكرة بشكل أفضل، حيث يتم تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بالأعمدة الطولية الملونة، والأجسام الأخرى بالحلقات العرضية باللون الأبيض باعتبار أنه من المفترض أنها لا تحمل صبغة سياسية لكن بها تنوع في الرؤى. حسب الشكل أدناه من أسفل تبدأ بلجان المقاومة على المستوى القاعدي، وهي موجودة في كل الأحياء السكنية في الريف والحضر. بعدها تأتي المنظمات النسوية بكل تنوعها: الحزبي، الحقوقي، المهني، وغيرها، والمفترض أن تكون أكثر ملامسة للقواعد الشعبية، ثم تأتي النقابات والروابط المهنية، والحلقة الأخيرة تشمل كل منظمات المجتمع المدني الأخرى، بما فيها المنظمات التي نشأت بعد الثورة مثل منظمة أسر الشهداء. وفقاً لهذا الترسيم لمنظومة قوى الثورة فإن الاتفاق أو الخلاف بين الأحزاب والتيارات السياسية ينعكس بشكل مباشر على تماسك الشبكات غير الحزبية. وقد أثبتت تجربة الفترة الانتقالية صحة هذا الادعاء، فقد انعكست الخلافات بين الأحزاب على كل الأجسام الأخرى، وقد تابعنا ما حدث في تجمع المهنيين وفي المجموعات النسوية السياسية والمدنية )منسم(، بل حتى في منظمة أسر الشهداء، ولجان المقاومة ليست ببعيدة عن هذه الانقسامات.
أردت أن أوضح بهذا الترسيم أنه مهما كانت درجة حماسنا للجان المقاومة وتقديرنا لأهمية الدور الذي قامت وستقوم به في هذه الثورة، إلا أنه لا يمكن فصلها عضوياً من التيارات السياسية سواء أكانت أحزاباً فاعلة في الساحة السياسية أو تيارات سياسية في مرحلة التشكل أو حتى مواقف سياسية رافضة بشكل عام للأحزاب. والمجموعة الأخيرة إما ينقصها الوعي بكيفية تداول السلطة في الدولة المدنية الديمقراطية، أو متأثرة بما تبثه الآلة الإعلامية للنظام البائد. في كل الحالات فإن المراهنة على قدرة لجان المقاومة على القيام بدور سياسي بمعزل عن الأحزاب السياسية عبارة عن وهم أو محاولة لإيهام الآخرين بحيادية هذه اللجان، وهذا لن يصمد كثيراً. ببساطة لو كانت لجان المقاومة بالفعل تمثل كل الثوار في الحي السكني المحدد سيكون هناك تباين في الرؤى السياسية، لأنه ليس هناك حي سكني محتكر لحزب محدد، وبالتالي وحدتها ستكون مرتبطة الاتفاق أو الخلاف بين الأحزاب. وفي حالة وجود لجان المقاومة منحازة لكيان حزبي محدد هذا مؤشر واضح لمحاولات الهيمنة على اللجان أكثر منه تمثيل حقيقي للثوار في الحي المحدد. ويبدو أن هناك معارك دائرة في الخفاء بين الأحزاب السياسية للهيمنة على لجان المقاومة وهذا لن يقوي مواقف هذه الأحزاب بقدر ما أنه سيضعف لجان المقاومة ودورها الآني في التحشيد ودورها المستقبلي في إرساء الممارسة الديمقراطية التشاركية التي تتم من أسفل إلى أعلى.
رغم أن هناك قطاعات واسعة غير راضية عن أداء الأحزاب السياسية بسبب ضعفها وعدم قدرتها على التطور والتحديث، أو لمحاولات بعضها الانفراد بالرأي أو الهيمنة، إلا أن ذلك ليس مبرراً للهجوم عليها ومحاولة الترويج لإمكانية تجاوزها. من المهم أيضاً التذكير بأن فكرة لجان المقاومة في الأحياء السكنية ليست فكرة جديدة، بل ابتكرتها الأحزاب، وكانت إحدى أدواتها المجربة في التحشيد للثورات والانتفاضات الشعبية. الاحتمالات الأرجح لهذا الاختلاف في الخطاب بين لجان المقاومة والأحزاب السياسية إما بسبب تجربة الحكومة الانتقالية الفاشلة خلال السنتين الماضيتين، أو لاختلاف الرؤى بين الأجيال داخل هذه الأحزاب التي في الغالب يقودها أشخاص من كبار السن. وبالتالي قد يكون ذلك نوعاً من الضغط الذي يمارسه الشباب على قياداتهم لاتخاذ مواقف أكثر راديكالية. استناداً على هذا الفهم الذي يؤكد الدور المفتاحي للأحزاب لا يستبعد توحيد قوى الثورة بواسطة لجان المقاومة في حالة اتفاق شباب وشابات الأحزاب الناشطين على مستوى لجان الأحياء على ميثاق سياسي، وقاموا بالضغط على قيادات أحزابهم لتبنيه. وهو أيضاً توافق حزبي يتم بطريقة عكسية تبدأ من أسفل إلى أعلى.
لذا أعتقد أن أقصر طريق لتوحيد قوى الثورة هو الاتفاق بين الأحزاب والتيارات السياسية المؤمنة حقيقة بالتحول المدني الديمقراطي، سواء جاء ذلك من أعلى، أي بواسطة قيادات الأحزاب، أو من أسفل بواسطة منسوبي الأحزاب في لجان المقاومة، أو المجموعات النسوية، أو حتى تجمع المهنيين الذي قام بدور مشابه واستطاع توحيد القوى السياسية في بداية ثورة ديسمبر، قبل أن تطاله الانقسامات. هذا يتطلب من الأحزاب الخروج من دائرة الصراعات والتناحر والتخوين إلى دائرة الفعل المشترك بقلوب وعقول مفتوحة وإرادة قوية للخروج بمشروع وطني متوافق عليه يرسي دعائم الدولة المدنية الديمقراطية. ويجب أن يشتمل المشروع على خطة استراتيجية واضحة لكيفية تفكيك دولة التمكين وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية والأمنية بأسس وتشريعات جديدة. وأيضاً يجب أن يتم الاتفاق حول كيفية إدارة الاقتصاد وحماية موارد الدولة المستباحة حالياً من مجموعات في الداخل مع دول إقليمية وعالمية. والأهم من ذلك وضع ترتيبات لإعداد الدستور الدائم لتتم إجازته قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
في الختام، هذه دعوة لقيادات الأحزاب بشكل خاص ولمنسوبيها في الشبكات غير الحزبية وللمهتمين بالشأن السياسي بصورة عامة، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية وبذل ما بوسعهم لتوحيد قوى الثورة لتتمكن من هزيمة الانقلاب بأقل الخسائر، وإنجاز التحول المدني الديمقراطي، وإلا ستتحمل الوزر الأكبر إذا انحرفت الثورة عن مسارها بسبب التلكؤ وطول زمن الحراك الثوري في هذا الوضع الهش الذي يهدد بالانزلاق في حالة فوضى وعنف واسع. نؤمن جميعنا بأن الردة المستحيلة، لكن كما قال الشهيد الخالد عبد السلام كشة: “نخشى على ثورتنا من النخب التي أدمنت الفشل”.
د. مريم محمد عبد الله وقيع الله
وصول جموع الثوار في الخرطوم إلى القصر الجمهوري في يومي 19 و25 ديسمبر الجاري، رغم الاستعدادات الأمنية غير المسبوقة والتي تنذر بارتكاب مجازر قد تفوق ما حدث في يوم 17 نوفمبر، يدل على استعداد الديسمبريين لتقديم مزيد من التضحيات في سبيل تحقيق حلمهم بالدولة المدنية الديمقراطية. لكنه في نفس الوقت كشف أن هذا الزخم الثوري غير المسبوق لا يزال يفتقد للقيادة السياسية المتحدة وخريطة طريق توضح ماذا بعد الوصول إلى ساحة القصر الجمهوري. معلوم أن هذه الربكة بسبب عدم قدرة قوى الثورة على تشكيل قيادة متحدة جديدة بعد تصدع تحالف قوى الحرية والتغيير الذي نجح في قيادة الثورة حتى إسقاط رأس النظام البائد في أبريل 2019، ولا أحد ينكر أن لجان المقاومة استطاعت سد الفراغ وقيادة الحراك الثوري حتى الآن، وفرضت سيادتها على مجريات الأحداث، على الرغم من أن انقلاب 25 أكتوبر لم يتمكن من تشكيل حكومته ولا شرعنة سلطته داخلياً أو خارجياً، حتى بعد توقيع الإعلان السياسي مع د. حمدوك، إلا أن ذلك لا يعني سهولة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي، بل بالأحرى يؤكد ذلك على عدم قدرة الانقلابيين على خلق وضع مستقر يعيد سلطة النظام البائد كما يحلم بعضهم، ولا خلق نظام سلطوي جديد كما يحلم البعض الآخر المسنود من دول إقليمية وعالمية. وبالتالي فإن قيام نظام سلطوي أحادي غير وارد، فهناك خياران فقط: إما استعادة مسار التحول الديمقراطي الذي يسمح ببناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة، أو الانزلاق في عنف واسع النطاق لن تقتصر آثاره على السودان، بل ستؤثر على الأقاليم المجاورة أفريقياً وعربياً، بل ستصل آثاره إلى أوروبا.
رغم أن قوى ثورة ديسمبر لديها إرادة قوية للتغيير وهدف واضح هو تحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة، إلا أن الخطأ الاكبر الذي وقعت فيه قيادات تحالف الحرية والتغيير أنهم بدأوا في التناحر وحولوا الاختلاف في الرؤى إلى خلاف بمجرد سقوط رأس النظام في أبريل 2019. والنتيجة كانت تصدع التحالف بأسرع مما كان متوقعاً، وبما أنهم كانوا بالفعل قد اتفقوا على ما يعرف بإعلان الحرية والتغيير الذي يعتبر مرجعية للانتقال المدني الديمقراطي )The terms of reference( كان يتوقع أن يشرعوا مباشرة في وضع استراتيجية لكيفية تحقيق هذا الانتقال على أرض الواقع، لكنهم قبل الاتفاق على ذلك دخلوا التفاوض وهم منقسمون. وهنا الحديث عن القيادات التي انفصلت عن قواعدها في هذه الفترة ومارست نوعاً من التعتيم غير المبرر، والنتيجة كانت الوثيقة الدستورية بعيوبها المعروفة. بدأت المرحلة الانتقالية في ظل هذا التشرذم، انشغل البعض بالمحاصصات لأخذ نصيبهم في الوزارات والوظائف القيادية، دون أن يدروا أنهم متورطون في العمل بمؤسسات لا يزال منسوبو النظام البائد والموالون له يتحكمون في كل مفاصلها. هذا يفضح جهلهم بهذا الواقع، ويؤكد عدم توفر استراتيجية أو خارطة طريق تحدد كيفية إحداث التغيير لمصلحة الدولة المدنية الديمقراطية. أما البعض الآخر ففضل لعب دور المعارضة وطالب بإسقاط حكومة الشراكة في تماهٍ غير مقصود مع مساعي فلول النظام البائد، وانتهي هذا الفصل بالانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية ووثيقتها الدستورية.
الدرس الذي يجب أن تستوعبه قيادات قوى الثورة هو أن التغيير من الحكم الأحادي السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن أن يقوم به فرد أو حزب أو تحالف حزبي محدود، ولا يمكن أن تقوم به مجموعة محدودة من النخب معزولة عن القاعدة الشعبية العريضة صاحبة المصلحة المباشرة من التغيير، لأن التغيير المنشود ليس تغييراً فوقياً باستبدال عسكريين بمدنيين أو منسوبي النظام البائد في المؤسسات بمنسوبي الأحزاب كما يعتقد البعض. بل هو تغيير جذري في منظومة الحكم بشكل كامل وإعادة بنائها وفقاً لأسس الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا لا يتم فقط بالنوايا الطيبة، بل يحتاج خطة محكمة تشارك في وضعها كل قوى الثورة، تبنى على قراءة شاملة للمشهد بكل تعقيداته، وتضع خارطة طريق واضحة ومرنة تحدد كيفية إحداث التغيير ومراحله. هذا يتطلب تشكيل قيادة متحدة ومتواصلة مع جماهير الثورة على كل المستويات، خاصة المستوى القاعدي، وهي الضمانة الوحيدة لتشكيل قوة شعبية متماسكة ذات وزن راجح في المعادلة السياسية، قادرة على إجبار العسكريين وفلول النظام البائد على التخلي عن أحلامهم بجر عجلة التاريخ إلى الوراء، وستجد في هذه الحالة الاحترام والثقة والدعم من الخارج كقوة تستطيع جلب الاستقرار لبلد له دور مفتاحي في استقرار المنطقة لموقعه الجغرافي. ورغم أن موقع السودان وثرواته المستباحة هو أحد أسباب التدخلات الإقليمية والدولية إلا أن استدامة الاستقرار له أهمية قصوى خاصة بالنسبة لأوروبا وأمريكا.
إن ضرورة تشكيل قيادة متحدة للثورة ليس عليها خلاف، إلا أن هناك رؤى مختلفة حول كيفية تشكيل هذه القيادة، في الآونة الأخيرة اتجهت الأنظار للجان المقاومة التي استطاعت قيادة الحراك الثوري في هذه المرحلة الحساسة تحت شعار “لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية”. وعلى ما يبدو أن الأحزاب السياسية التي شاركت في المرحلة السابقة اضطرت للتماشي مع هذا الشعار، والذي هو أقرب لطرح الأحزاب التي كانت تعارض الشراكة، وعلى رأسها الحزب الشيوعي. هناك أيضاً من يؤمل في أن يتوحد تجمع المهنيين الذي تفتت بسبب الخلافات بين الأحزاب ليقود الحراك مرة أخرى كما فعل في 2018. وآخرون يراهنون على قدرة الحراك الثوري على إفراز قيادة جديدة في الوقت المناسب ولا يرون داعياً للاستعجال، وفي نفس الوقت تعج الساحة السياسة بالكثير من المبادرات والمواثيق والبرامج المطروحة أمام قوى الثورة للاتفاق حولها، إلا أن الانقسام ما زال قائماً، وأعتقد أن السبب الأساسي يرجع للأحزاب السياسية التي يعتبر دورها مفتاحياً في توحيد قوى الثورة. فيما يلي سأحاول ترسيم منظومة قوى الثورة لشرح هذه الفكرة:
لقد ساهم الانقلابفي ترسيم حد فاصل بشكل أوضح بين مجموعتين: إحداهما تسعى لاستعادة النظام السلطوي القديم المبني على الهيمنة والتهميش وما يستبعه من قمع ومصادرة للحريات، والأخرى تسعى لتحقيق نظام مدني ديمقراطي تعددي مبني على قيم الحرية والسلام والعدالة، الجديد في الأمر هو انحياز معظم قادة الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا لكفة الانقلابيين. لن أسترسل كثيراً في تحليل القوى الانقلابية رغم أنها مهددة بالصراعات من الداخل مما سيضعفها لصالح قوى الثورة، بل سأركز هنا على ترسيم منظومة قوى الثورة التي يقع عليها عبء إسقاط النظام وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية.
قوى الثورة تتكون من مجموعتين رئيسيتين تختلفان في طبيعتيهما وتتكاملان في أدوارهما داخل هذه المنظومة: المجموعة الأولى تشمل الأحزاب السياسية وأخرى تشمل كل الشبكات غير الحزبية بما في ذلك: لجان المقاومة، المنظمات النسوية، النقابات والروابط المهنية، وغيرها من منظمات المجتمع المدني. لكل من الأحزاب السياسية مقاربة لكيفية إدارة مؤسسات الدولة واستغلال مواردها لفئات المجتمع المختلفة، وفي الغالب تستند هذه المقاربات على تصور نظري مبني على أسس ومبادئ محددة ونموذج عملي لكيفية الممارسة. رغم أن نسبة الأشخاص المنظمين في الأحزاب قد تكون ضئيلة إلا أن الغالبية العظمى غير المنتمية لأحزاب لديها ميول لحزب دون الآخر. تضح هذه الميول في العملية الانتخابية إذا كانت بالفعل تتم بنزاهة ووعي كامل بالفرق بين المقاربات المختلفة. القصد هنا ليس معرفة مدى شعبية هذه الأحزاب، بل الأهم هو إبراز هذا التنوع في وجهات النظر والإقرار بأن هناك مقاربات سياسية مختلفة. فكرة الدولة المدنية الديمقراطية تبدأ من هذا المبدأ، وهو الإقرار بالتنوع ومبدأ الحرية في أن يتبنى كل شخص المقاربة التي يتفق معها ويرى أنها الأنسب أو التي تلبي مصالحه، وفي نفس الوقت لدى هذه الأحزاب الحق في الترويج لمشروعها إعلامياً، فلا ديمقراطية دون أحزاب، فمن يرفض الأحزاب الموجودة يجب أن ينخرط مباشرة في تشكيل حزب جديد يمكن أن يتنافس مع الأحزاب القائمة دون إقصائها، فلكل مقاربته للحلول السياسية ولديه جماهيره. أما بالنسبة للشبكات غير الحزبية فهي في الغالب تحاول التركيز على مطالب وحقوق الفئات المختلفة وإلقاء الضوء على مدى تأثر متطلبات الحياة اليومية للمجموعات المختلفة بالسياسات والممارسات المحددة، وبالتالي يتقاطع مجال اهتمامها مع المقاربات والممارسات السياسية المختلفة. وفي نفس الوقت فإن الناشطين في هذه الشبكات في الغالب يتبنون مقاربات سياسية مختلفة لتحقيق مطالبهم وحقوقهم الفئوية، لذا فهم أيضاً مجموعات غير متجانسة سياسياً.
الشكل أدناه يوضح هذه الفكرة بشكل أفضل، حيث يتم تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بالأعمدة الطولية الملونة، والأجسام الأخرى بالحلقات العرضية باللون الأبيض باعتبار أنه من المفترض أنها لا تحمل صبغة سياسية لكن بها تنوع في الرؤى. حسب الشكل أدناه من أسفل تبدأ بلجان المقاومة على المستوى القاعدي، وهي موجودة في كل الأحياء السكنية في الريف والحضر. بعدها تأتي المنظمات النسوية بكل تنوعها: الحزبي، الحقوقي، المهني، وغيرها، والمفترض أن تكون أكثر ملامسة للقواعد الشعبية، ثم تأتي النقابات والروابط المهنية، والحلقة الأخيرة تشمل كل منظمات المجتمع المدني الأخرى، بما فيها المنظمات التي نشأت بعد الثورة مثل منظمة أسر الشهداء. وفقاً لهذا الترسيم لمنظومة قوى الثورة فإن الاتفاق أو الخلاف بين الأحزاب والتيارات السياسية ينعكس بشكل مباشر على تماسك الشبكات غير الحزبية. وقد أثبتت تجربة الفترة الانتقالية صحة هذا الادعاء، فقد انعكست الخلافات بين الأحزاب على كل الأجسام الأخرى، وقد تابعنا ما حدث في تجمع المهنيين وفي المجموعات النسوية السياسية والمدنية )منسم(، بل حتى في منظمة أسر الشهداء، ولجان المقاومة ليست ببعيدة عن هذه الانقسامات.
أردت أن أوضح بهذا الترسيم أنه مهما كانت درجة حماسنا للجان المقاومة وتقديرنا لأهمية الدور الذي قامت وستقوم به في هذه الثورة، إلا أنه لا يمكن فصلها عضوياً من التيارات السياسية سواء أكانت أحزاباً فاعلة في الساحة السياسية أو تيارات سياسية في مرحلة التشكل أو حتى مواقف سياسية رافضة بشكل عام للأحزاب. والمجموعة الأخيرة إما ينقصها الوعي بكيفية تداول السلطة في الدولة المدنية الديمقراطية، أو متأثرة بما تبثه الآلة الإعلامية للنظام البائد. في كل الحالات فإن المراهنة على قدرة لجان المقاومة على القيام بدور سياسي بمعزل عن الأحزاب السياسية عبارة عن وهم أو محاولة لإيهام الآخرين بحيادية هذه اللجان، وهذا لن يصمد كثيراً. ببساطة لو كانت لجان المقاومة بالفعل تمثل كل الثوار في الحي السكني المحدد سيكون هناك تباين في الرؤى السياسية، لأنه ليس هناك حي سكني محتكر لحزب محدد، وبالتالي وحدتها ستكون مرتبطة الاتفاق أو الخلاف بين الأحزاب. وفي حالة وجود لجان المقاومة منحازة لكيان حزبي محدد هذا مؤشر واضح لمحاولات الهيمنة على اللجان أكثر منه تمثيل حقيقي للثوار في الحي المحدد. ويبدو أن هناك معارك دائرة في الخفاء بين الأحزاب السياسية للهيمنة على لجان المقاومة وهذا لن يقوي مواقف هذه الأحزاب بقدر ما أنه سيضعف لجان المقاومة ودورها الآني في التحشيد ودورها المستقبلي في إرساء الممارسة الديمقراطية التشاركية التي تتم من أسفل إلى أعلى.
رغم أن هناك قطاعات واسعة غير راضية عن أداء الأحزاب السياسية بسبب ضعفها وعدم قدرتها على التطور والتحديث، أو لمحاولات بعضها الانفراد بالرأي أو الهيمنة، إلا أن ذلك ليس مبرراً للهجوم عليها ومحاولة الترويج لإمكانية تجاوزها. من المهم أيضاً التذكير بأن فكرة لجان المقاومة في الأحياء السكنية ليست فكرة جديدة، بل ابتكرتها الأحزاب، وكانت إحدى أدواتها المجربة في التحشيد للثورات والانتفاضات الشعبية. الاحتمالات الأرجح لهذا الاختلاف في الخطاب بين لجان المقاومة والأحزاب السياسية إما بسبب تجربة الحكومة الانتقالية الفاشلة خلال السنتين الماضيتين، أو لاختلاف الرؤى بين الأجيال داخل هذه الأحزاب التي في الغالب يقودها أشخاص من كبار السن. وبالتالي قد يكون ذلك نوعاً من الضغط الذي يمارسه الشباب على قياداتهم لاتخاذ مواقف أكثر راديكالية. استناداً على هذا الفهم الذي يؤكد الدور المفتاحي للأحزاب لا يستبعد توحيد قوى الثورة بواسطة لجان المقاومة في حالة اتفاق شباب وشابات الأحزاب الناشطين على مستوى لجان الأحياء على ميثاق سياسي، وقاموا بالضغط على قيادات أحزابهم لتبنيه. وهو أيضاً توافق حزبي يتم بطريقة عكسية تبدأ من أسفل إلى أعلى.
لذا أعتقد أن أقصر طريق لتوحيد قوى الثورة هو الاتفاق بين الأحزاب والتيارات السياسية المؤمنة حقيقة بالتحول المدني الديمقراطي، سواء جاء ذلك من أعلى، أي بواسطة قيادات الأحزاب، أو من أسفل بواسطة منسوبي الأحزاب في لجان المقاومة، أو المجموعات النسوية، أو حتى تجمع المهنيين الذي قام بدور مشابه واستطاع توحيد القوى السياسية في بداية ثورة ديسمبر، قبل أن تطاله الانقسامات. هذا يتطلب من الأحزاب الخروج من دائرة الصراعات والتناحر والتخوين إلى دائرة الفعل المشترك بقلوب وعقول مفتوحة وإرادة قوية للخروج بمشروع وطني متوافق عليه يرسي دعائم الدولة المدنية الديمقراطية. ويجب أن يشتمل المشروع على خطة استراتيجية واضحة لكيفية تفكيك دولة التمكين وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية والأمنية بأسس وتشريعات جديدة. وأيضاً يجب أن يتم الاتفاق حول كيفية إدارة الاقتصاد وحماية موارد الدولة المستباحة حالياً من مجموعات في الداخل مع دول إقليمية وعالمية. والأهم من ذلك وضع ترتيبات لإعداد الدستور الدائم لتتم إجازته قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
في الختام، هذه دعوة لقيادات الأحزاب بشكل خاص ولمنسوبيها في الشبكات غير الحزبية وللمهتمين بالشأن السياسي بصورة عامة، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية وبذل ما بوسعهم لتوحيد قوى الثورة لتتمكن من هزيمة الانقلاب بأقل الخسائر، وإنجاز التحول المدني الديمقراطي، وإلا ستتحمل الوزر الأكبر إذا انحرفت الثورة عن مسارها بسبب التلكؤ وطول زمن الحراك الثوري في هذا الوضع الهش الذي يهدد بالانزلاق في حالة فوضى وعنف واسع. نؤمن جميعنا بأن الردة المستحيلة، لكن كما قال الشهيد الخالد عبد السلام كشة: “نخشى على ثورتنا من النخب التي أدمنت الفشل”.